قبل ما يقارب الثلاثين عاماً شاهدت مسلسل “على الدنيا السلام” الكوميدي الكويتي. كنتُ وقتها صغيراً جداً.. وكان القلاف يضحكني بطريقته بلفظ اسم بطلتي المسلسل محظوظة ومبروكة. ولربما يمكنني القول بأنه يستحيل على أي من أبناء جيلي ممن ولدوا وعاشوا في الكويت ألا يدخلوا جو هذه الرواية بسهولة. كل شيء فيها، ذلك الإغراق في ركن المكان الذي تخضع له الرواية، تلك الذكريات القديمة من أغنيات، وأحداث كحوادث المقاهي الشعبية وخطف الجابرية وبطولة الصداقة والسلام إلى ذلك الصيف الأسود عام 1990.
إن السنعوسي يذكرنا بتقديمه للتاريخ من خلال الرواية بالتقديم التاريخي الموظف بامتياز في الروايات الروسية. تولستوي مع الحملة الروسية في الحرب والسلام على سبيل المثال لا الحصر. ويذكرنا حتى بمسلسل آخر وظف فيه التقديم التاريخي بشكل ممتاز وهو “ليالي الحلمية” المصري الشهير والذي كان من تأليف أسامة أنور عكاشة.
مما لا شك فيه، اهتمام السنعوسي بالتقنية الروائية. فهو يعرض فكرته من خلال استخدامه لثلاث أزمنة في ذات الوقت. ولكي ينجح في ذلك قام باستخدام حيلة لطيفة.. أن البطل “كتكوت” قد كتب رواية اسمها “إرث النار” وكان السنعوسي يعرض لنا فصلاً من أحداث الزمن الحاضر –وهو المستقبل بالنسبة لنا- يليه فصل من رواية إرث النار. والجميل هنا، هو أن رواية إرث النار قد كتبها كتكوت عن حياته بالفعل.. إنما عن الزمن الماضي. أي أن تتالي الزمن بين الفصول يكون كالتالي: حاضر، ماضي، حاضر وهكذا. وقد يسبب هذا بالإضافة للإغراق المكاني واستخدامه للذاكرة الشعبية الكويتية صعوبة للقاريء غير المطلع على الثقافة الكويتية. وهذا يبرر لنا صعوبة النصف الأول من الرواية على الكثيرين ممن قرؤوها.
عام 1990 كان مفصلياً في تاريخ الكويت. ومما لا شك فيه. أن أحداث غزو العراق للكويت كانت صدمة عنيفة للوعي الكويتي. فالكويت ما قبل 1990 ليست هي ذاتها ما بعده أبداً.. ومن الجميل أن نرى ذلك معكوساً على بنية الرواية فنجد أن تسلسل الزمن الذي أشرتُ إليه سابقاً يختل حين يصل لهذا الزمن.. لنجد الفصول تتوالى عن ذات الزمن وهو فترة إحتلال العراق للكويت –سبعة شهور- إلى فترة التحرير. وما بعد التحرير يرجع التسلسل الزمني كما كان قبل فترة الغزو. وفي الواقع، كان عام 1990 مفصلياً للأمة العربية بأكملها.. ومن المثير للسخرية مدى الضرر الذي أدت إليه للقضية الفلسطينية خاصة مع الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الداعم علناً لغزو الكويت. رغم أن القضية الفلسطينية كلها قائمة على قاعدة عدم أحقية احتلال دولة لأخرى في العصر الحديث ! كما أنه لم يمكن لأوسلو أن تكون لولا حادثة غزو الكويت. بعد غزو الكويت لم تعد فلسطين ذاتها. فقد أصبحت الضفة الغربية وغزة فقط في عيون القيادة الفلسطينية. في مشهد كاريكاتوري يعيد للأذهان كاريكاتور ناجي العلي الشهير الذي يصور فيه خيبة الأمل الفلسطينية من محمود درويش حين دعا للتعايش العربي اليهودي في ظل دولة واحدة. بعد عام 1990، لم تتوقف الخيبات بالتوالي..
للرواية تقسيم آخر، وهو من خلال الفئران الأربعة؛ شرر، لظى، جمر، وأخيراً مع رماد. وهؤلاء هم فئران أمي حصة.. وهي الحكاية التي لم تحكها حصة الجارة العجوز للكتكوت حين كان كتكوتاً حقاً. وحين كبر الكتكوت ليصبح ديكاً “منتوفاً” لا يقوى على شيء سوى الصياح قرر أن يكتب رواية إرث النار ليحذر الناس من الفئران تماماً كما فعلت فؤادة المجنونة في مسلسله المفضل القديم.
بدأت الرواية من مشهد كئيب في الحاضر وهذا الحاضر لا يشكل سوى أحداث يوم واحد فقط من ذلك المستقبل الكريه الذي يحذرنا السنعوسي منه لو بقيت الأمور على ما هي عليه. هو مشهد غامض.. حيث الكتكوت قد تعرَض إلى ما يشبه الحادث.. بركبة مرضوضة بقوة.. وسن مفقود.. وآلام في مؤخرة رأسه.. وسيارة مهشمة.. ولا يوضح لنا السنعوسي حقيقة ما حدث إلا في آخر قسم من الرواية.. رماد.
نلاحظ مدى ضحالة علاقة الكتكوت بوالده الذي يحتكر المال جلّ اهتمامه؛ فهذا الرجل الذي يتحسر على النفط الذي احترق في نهاية الغزو.. ويهتم بسوق المال أكثر من اهتمامه بكل ما يحدث من حوله. أما تأثير والدة الكتكوت فهو ينحصر بالتغليظ على ولدها بالأيمان العظيمة. هي تحبه بلا شك وتحرص عليه. ومن المثير أن نشاهد مدى تأثر وتعلّق الكتكوت بجيرانه والعجوز حصة بالذات مقارنةً بذويه.. ولربما كانت تلك الشهور الـسبع التي قضاها في منزلهم يبيت في غرفة العجوز حصة دور كبير في ذلك.
كتكوت وأيوب يمثلان أفراداً أصحاء، لا يستطيع الطاعون الإقتراب منهما وهما لتلك “البركة” يستطيعون شم تلك الرائحة الكريهة الحمضية التي تنبيء بوجود فئران في الجوار ! ومن الملفت أن نرى أن تنشئة كتكوت وأيوب هي لربما المسؤولة عن مثل هذه الحصانة ضد طاعون الطائفية. لكن، هناك نماذج أخرى في الرواية؛ صالح ابن حصة العجوز ووالد فهد من جهة.. ومن جهة أخرى؛ عباس ابن زينب ووالد صادق. وهما جارا الكتكوت وكان ثلاثتهم الكتكوت وفهد وصادق يقضون وقتهم معاً معظم الوقت في طفولتهم. إذن، صالح هو رجل سني قبلي.. متقلب في تعصبه حسب الزمن.. فهو زمن عبد الناصر كان متعصباً له وزمن قادسية صدام كان متعصباً له.. وما بعد 1990 بدأ في التعصب لمذهبه. بينما عباس رجل شيعي.. كان من البداهة أن ينحاز لصف الدفاع المقدس “اسم الحرب العراقية الإيرانية بالنسبة للشيعة”. لكن، هنا تكمن مشكلة حقيقية. كان العراق يحارب إيران ليس من منطلق مذهبي. بل لتصفية حساب قديم مع إيران ويحدث أن الوقت فيما بعد الثورة الإيرانية عام 1979 مناسباً جداً للعراق كي يصفي ذلك الحساب.. وبدأ في ذلك بالفعل عام 1980. حيث أنه من المعروف أنه وبسبب ثورة 1979 كان الجيش الإيراني في أضعف حالاته بسبب تصفية الجنرالات الموالين للشاه وإعادة هيكلة شاملة للجيش الإيراني فيما بعد الثورة. أي أن الحرب لم تكن لأسباب طائفية. فقد كان الجيش العراقي يحتوي على السني والشيعي يحاربان معاً جنباً لجنب ضد إيران. لكن ما حدث فيما بعد هو أن تم توظيف المذاهب لشحذ الهمم في دعم كل طرف.
من البديهي لكل العرب أن يقفوا خلف العراق. ومن البديهي أن تستغل القوى العالمية هذه الحرب لبيع الأسلحة وكلنا يعرف فضيحة إيران غيت زمن ولاية الرئيس رونالد ريغان الثانية والتي تم الكشف عنها حيث أن الولايات المتحدة التي كانت تدعم العراق علناً بالسلاح كانت أيضاً تبيع السلاح لإيران ! ما يهم هنا، هو أن عباس رغم أحداث المقاهي الشعبية واختطاف الجابرية كان متعاطفاً مع إيران. مع إحترامي الشديد لأي اعتبارات مذهبية. لكن، ألا يعتبر هذا السلوك خيانة لو كان في دولة أخرى وظروف أخرى ؟ التعصب مكروه على أي حال بكل تأكيد. وسلوك عباس هذا لا يجعل صالح رجلاً مخلصاً لوطنه أكثر. فعقلية التعصب لدى عباس هي ما دفعته لموالاة إيران.. وصالح يمتلك ذات العقلية إنما يحدث أن لها اتجاهاً مختلفاً. هذا كل شيء. ورغم أنهما قد أسرا أثناء الغزو العراقي للكويت. إلا أن ذلك لم يغير شيئاً في عقليتهما.. ومن المؤسف جداً أن نرى الحالة الوحيدة التي اتفقا فيها هي حين طردا أبا نائل الفلسطيني من منطقتهم بعد التحرير. وحينها برر صالح موقفه لابنه بأنه يطبق مبدأ أنا وابن عمي على الغريب. كم فعلت السياسة بنا الأفاعيل ! أعجبتني محاولة السنعوسي الموضوعية مع الجميع، فأظهر الطرف المخلص من الفلسطينين في الكويت.. وأظهر الطرف الخائن.. أظهر الجانب الجيد من أهل بلاده.. كما أظهر سلوكهم المشين. كما أظهر العراقي الغازي المجرم، وأظهر العراقي الشهم الذي قام بإعطائهم نقود الرشوة كي يتمكنوا من زيارة صالح وعباس في سجن البصرة. إنه من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك في كل قوم. أليست تلك هي الحال دوماً ؟ فلا قوم يحتكرون الخير كله أو الشر كله. لكن ما يحدث هو أننا نزر وازرة بأخرى في كثير من الأحيان. وهكذا وصم كل العراقيين بالعار لدى الكويتيين مما اضطر من ينتمون لأصول عراقية من الكويتيين أنفسهم أن يخفوا ذلك.. كما فعل صادق حين كان يشير إلى جدته زينب العراقية أنها من الإحساء. حتى زينب المسكينة، أصبحت تحاول جاهدة إخفاء لهجتها التي تفضحها.
وتضطر لمشاهدة المسرحيات التي تسخر من العراقيين كعراقيين لا كغزاة إلى الدرجة التي لم تعد لها القدرة على التحمل لتغادر المكان متحدثة بلهجتها العراقية أنه لا، العراقيون ليسوا هكذا.. بينما كان صالح غارقاً في ضحكاته. وبذات المنطق طرد “الزلمات” من الكويت. لقد أعجبتني عزة نفس أبي نائل وكرامته حين طرد فلم يفتح المجال لهما للكلام.. بل عبّر عن قراره بالخروج من الكويت إلى الأردن برغبته هو. إنها ثقافة الكراهية وأن نسم القوم كلهم بجائرة قام بها بعضهم. إنها ثقافة “لكي لا ننسى” الموجهة بشكل أعمى اتجاه التعميم. لا عجب، ان تكون فوزية هي المبصرة بينهم في الظلام كما حدث فيما بعد.
للحرية دوماً ثمن، ولهذا كان الأمر حين عاد البرلمان مرة أخرى في الكويت أسيء استخدام هذه الحرية بشكل كبير.. حيث كانت كل طائفة تنشر الكراهية المذهبية في المجتمع من خلال الإعلام وغيرها. لتقترب الفئران أكثر وأكثر. ليصل الأمر حداً خطيراً بعد سقوط بغداد 2003 في الغزو الأمريكي لها.. بدأت الأمور تتفاعل بسرعة أكبر في الكويت.. وازداد الأمر خطورة مع الثورات العربية الأخرى.. والتي تحولت فجأة إلى حرب طائفية بدورها !
من السهل على العقل العربي الانجراف مع التعصب. أياً كان مرده. أليست تلك هي الجاهلية التي حذرنا منها عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ إنها ليست مقصورة على القبيلة أو النسب.. إنها تمتد للقوميات والمذاهب وكل انتماء. ألم يتنقل صالح بين تعليق صورة صنم وأخرى إلى أن انتهى إلى صنم اسمه المذهب في قلبه ؟ تلك هي الحال دوماً.. إن العربي يبحث دوماً له عن صنم جديد.. فلم تهدم كل الأصنام يوم فتح مكة.. بقي صنم واحد في قلب العربي. قد يكون متوارياً عن الأنظار، لا يرى. لكن، يمكن له النمو والإنتشار إذا ما وجد له تربة خصبة في ذلك القلب وتمت من بعد ذلك تغذيته. ومن المثير أن نرى السنعوسي يرجعنا إلى الإرهاصات الأولى لبذرة الطائفية –الفئران- حين نجد ذلك الطفل الضخم يتنمر على صادق بالمدرسة ويسأله مستنكراً: وهل أنت عربي ؟ وفي ذلك إشارة لأصول صادق لكونه من الذين هاجروا من بلاد فارس –قبل أن تصبح إيران اليوم- إلى الكويت وأصبحوا كويتيين. إذن، فالأصل حقاً جاهلي، لأن التمييز يبدأ من هنا، من القبيلة والنسب قبل أن يتخذ شكله المذهبي اليوم. ويمكننا أن نرى ذلك في أماكن أخرى وغير متعلقة بالدين. ففي الأردن مثلاً لا نزال نجد من يميز بين أردني وفلسطيني رغم أنهما من نفس الدين والمذهب ولربما هما نسيبان كذلك مثل فهد وصادق.
هل يمكنني حقاً أن أجرؤ بحصر هذا على العقلية العربية ؟ إطلاقاً، فقد قرأتُ أن العقلية المتعصبة ضد السود مثلاً تأخذ وقتاً طويلاً جداً للتعافي من فكرة التمييز ضد السود المزروعة عميقاً في لا وعيهم. وهي مشكلة أصيلة في مجتمع كالولايات المتحدة على سبيل المثال التي ورغم تحرير العبيد منذ أكثر من 100 عام إلا أننا لا نزال نسمع عن أحداث متفرقة لرجل أسود يقتل بدم بارد على يد شرطي أبيض وأعمال شغب فيرغسون ليست ببعيدة. نعم، فالفئران لها أنواع مختلفة. ولا يهم أيها يصلنا.. فأي واحد منها أكثر من كافٍ ليصيبنا بالطاعون.
نرجع لروايتنا، هذا الإرث الثقيل لصالح وصادق وصل أخيراً لولديهما فهد وكان يظهر بينهما بين فترة وأخرى رغم أنهما أصدقاء ورغم حقيقة أن فهد يحب أخت صادق.. حوراء. ثم نجد نموذجاً آخر وهو ضاري أو كما يلفظها “ضاوي” ابن الشهيد حسن. والذي كان من المقاومة الكويتية ضد الغزو العراقي. وهو في ذات الوقت خال كتكوت. والذي استحال فيما بعد لرجل ذا فكر “قاعدي” قبل أن يعود عن ذلك ويوافق على أن يكون إلى جانب كتكوت وأيوب وفهد وصادق كـ”عيال فؤادة”. وهي الجماعة التي اتفق الخمسة على تشكيلها بتأثير كتكوت وأيوب للتحذير من الفئران !
أعجبني اهتمام السنعوسي بالأثر النفسي للصدمات العصبية التي تمر فيها شخوص الرواية.. تلك الراء التي استحالت واواً لدى ضاري بعد أن رأى العراقيين يقتلون اثنين من المقاومة الكويتية أمام بيته.. وتلك الرغبة الجامحة لحوراء بأن تستأصل ثديها الأيمن الذي قتل ابنها البكر خطأً حين ناما وهي ترضعه. حوراء لم تعد لحياتها إلا بعد أن استأصلته حين استجاب جسدها لرغبتها تلك في لاوعيها وأصيب ذلك الثدي الأيمن بالذات بالسرطان. وكم كانت سعيدة حين قال لها الطبيب آسفاً بأنه قد يضطر لاستئصاله لها.. فشكرته وهو لا يدري لماذا. بينما ضاري لم يتعافَ أبداً مما تركه ذلك المشهد حتى مات حرقاً وهو صائم بحريق أشعلته الفئران.
الرواية مليئة بالرمزيات التي لا نهاية لها، ابتداءً من اسم كتكوت ذاته.. وهو الاسم الذي أطلقته عليه فوزية ابنة حصة وعمة فهد. والرمزية هنا في أن حصة كانت تخبره أن الفئران لا تستطيع مهاجمة بيض الدجاج إلا المكسور منه.. ذلك الذي يسيل منه الزلال.. وبما أن الكتكوت قد خرج من البيضة بالفعل فإنه ليس بإمكان الفئران أن تتمكن منه أبداً.. وهذا بالضبط ما كان. وحكاية سهيل وشهاب الصديقان اللذان دخلت بينهما الفئران ففرقتهما إلى الأبد. قد يكونان الأصدقاء فهد وصادق.. أو كتكوت ذاته وفهد ومع تلك النهاية المأساوية التي آلت إليها الرواية في مشهدها التوضيحي للمشهد الذي بدأت فيه. والمثير في هذا المشهد أن تعلّق الكتكوت بخرافات مثل قلب النعال يكون وجهه للأرض.. خوفاً من أن تسقط علينا السماء ! منعه من أن يمنع الكارثة من الحصول فيما بين فهد وصادق. إن كان ثمة سقوط للسماء حقاً على حياة الكتكوت فهو قد حصل بالفعل مما حدث بين فهد وصادق في تلك اللحظة. وأخيراً المشهد الأخير الذي انتهت به الرواية والذي نرى فيه كيف أن كتكوت وأيوب “فقط” أي الذين لا تمسهم الفئران هاجموا بالفعل الفئران بينما كانت تتقاتل فيما بينها. وتنتهي الرواية بالفعل بالأمل الذي يأتي بأنهما قد ينجوان منها حقاً من خلال فعل الركض.
هل هذه الرواية تمثل نبوءة مشؤومة لما هو قادم ؟ إطلاقاً، إنها صرخة تحذير.. الفئران آتية، احموا الناس من الطاعون. ولربما أسمع في الخلفية عبد الحسين عبد الرضا بشعره الأبيض وشواربه المميزة البيضاء وهو يقول بصوت حزين، مبحوح: “نبي نعيش”. كنتُ قد رأيتُ الكويت في دمار مرةً على شاشات التلفاز في برامج كـ”لكي لا ننسى” من قبل ولا أراني الله فيها دماراً بعدها أبداً.. هي وسائر الوطن.. اللهم آمين.. لقد حدد السنعوسي في هذه الرواية ما الذي يجب عدم نسيانه بالنسبة للكويتيين فيقول: تمسد رأسي. تعدد الأشياء التي لا تريد لي نسيانها؛ لا تنسى أن الكويتيين عملوا في جمع القمامة بعدما كانوا ملوكاً في بلادهم. لا تنسى أننا أصبحنا لاجئين في ليلة وضحاها في شتى بقاع الأرض. لا تنسى أن بعضنا، رغم إعانات الحكومة في المنفى، عاش على التبرعات طيلة أشهر الإحتلال. لا تنسى أن البعض ضحى بحياته من أجل وطنه. لا تنسى أننا نسينا كل خلافاتنا واختلافاتنا من أجل بلادنا. لا تنسى أنك لا تساوي شيئاً من دون وطنك. ثم أخيراً، والأهم، لا تنسى أن الدنيا تدور ! هذه العبارات، يمكننا تعميمها مع تحوير بسيط لتوائم سائر الوطن على اتساعه.
أحاول بالعادة الإختصار في مراجعاتي، لكن مع عمل من هذا النوع.. يستحيل عليّ فعل ذلك.
باختصار، هذه الرواية في غاية الأهمية.. وفي غاية الذكاء. وإن كانت خصوصية الثقافة الكويتية قد تجعلها صعبة بعض الشيء لمن هو ليس على إطلاع مسبق عليها. لكنني أعتقد حقاً أنها ستصبح وتظل طويلاً علامة بارزة في الرواية العربية.
بقلم د محمد حمدان
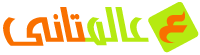




















0 Comments