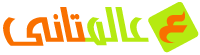كتاب دم المماليك – وليد فكري – كتاب صوتي
زيادة عن 20 سلطانًا اختتمت حياتهم بالاغتيال أو الإعدام أو شابت مصرعهم شبهة اغتيال..
مؤامرات ومؤامرات مضادة بين الأمراء بعضهم وبعض، أو بينهم وبين السلاطين..
ذاك جزء متواضع من رصيد القلاقِل في العصر المملوكي الواسع بين عاميّ 1250م و1517م والذي كان تشريع تبادل السلطة فيه هو قاعدة “الحكم لمن غلب” المنسوبة تاريخيًا للسلطان العادل الأيوبي..عن ذلك العصر المشتعل بالأحداث، عن نهايات من قضوا نحبهم من سلاطين المماليك اغتيالًا أو إعدامًا أو في قتال لحماية عروشهم.. عن ذاك الخيط الطويل من دم المماليك… نتحدث..يمنح الكاتب وليد فكري رأي الاغتيالات على أساس أنها النقطة الأولي للاختلاف ما بين عصر المماليك، وما بين العصور الفائتة لهذا، ولذا الشأن ترتب فوقه عدد من شكل الوجه التي ميّزت عصر المماليك:1. لم يحتسب المسألة جاريًا على مبدأ الوراثة مثلما كان الحال من قبل، وفي قليل من الأحيان راعى المماليك تلك الأمر، إلا أن لم يكن الغاية من هذا إلا صنيع عدد محدود من التحالفات بين الأمراء.
2. لم تكن الروابط السجل بين المماليك وبعضهم القلائل مرتكزة على الارتباط الأسري أو القبلي، بل وقفت على قدميها أساسًا على مبادئ تقدير ومراعاة الشدة والزعامات.
3. تشييدً على ذاك، يتوقع أن أن نجد مبدأ «الحكم لمن غلب» هو الأكثر ضبط تلك المرحلة، فمن عنده الشدة والقدرات يفلح في إحكام القبضة على الحكم، ومن ثم يسعى كل فرد إقصاء الآخرين بأساليب عنف وغير مشروعية بالمرة بهدف النجاح بالحكم، ومحاولة الوالي حماية وحفظ ما لديه بجميع طاقته، لأنّه يدري بأنّه لو رحل عن مقره لن تكون نهايته طيبة، فيوضح المبدأ الـ2 لتلك المرحلة «الوالي إما في القصر أو في الضريح».[3]
كل تلك الموضوعات على الأرجح تفسر لنا سر التقلبات الشرسة التي أصابت عصر المماليك، فانتشر التآمر بين الأمراء، وظهرت المؤامرات بغزارة شديدة، وأمسى المناحرة المستديم هو الموقف التي يقطن فيها السلطان، إمّا يجدي في حماية وحفظ موقعه، أو يُهزم ويخاف بعدها من القتل والرصد، وبذلك الشأن فيما يتعلق لمن يواجههم، فهي موقعة إمّا قاتل أو قتيل.
سلطان صبي وأمير متحكم
لقي حتفه السلطان الجلي برقوق، فحُسئم الأمراء ابنه الناصر فرج إلى العرش وهو ابن العاشرة، وأتموا له الشعائر، من أيمان مغلظة بالولاء وإلزام من الخليفة وانحناء وتقبيل للأرض بين يديه، إلخ… ما علينا من ذاك المرأى المكرر، والمكررة معه لعبة «لقي حتفه السلطان العظيم… هاتوا ابنه الضئيل وسلطنوه، ليصير ألعوبة لنا، وحل وسط يحجب تصارعنا على العرش… وإذا أتى يوم وأزاح أحدنا الآخر وركب السلطان، فحلال فوقه ركوبته، أو محرّم، لا تفرق عديدًا فالنتيجة واحدة: سلطان صبي وأمير متحكم».[4]
لعل تلك هي الظاهرة الأكثر شيوعًا طوال مدة حكم المماليك، فعلى الرغم من عدم اعترافهم بمبدأ الوراثة في الحكم، إلّا أنّ وجود غلام في موقع السلطان ثبت في العدد الكبير من المرّات، ويكون الحكم الفعلي لأمير، يضطلع بـ مسئولية البلاد متدرجًا حتى يصبح هو الوالي.
وفي وضعية إنعدام وجود اختيار معين لهوية الفرد الذي سوف يضطلع بـ شؤون الحكم، فإنّ الصراعات والفتن تصبح أمتن، فيعمل كل طرف على الإعداد للطريقة التي تُمكنه من البلوغ إلى الحكم وإقصاء الآخرين، وهو الذي يشير إلى شلالًا مودرنًا من الدماء.
غير ممكن القول بأنّ حدوث ذلك الشأن في جميع مرة كان المبتغى من خلفه نية سيئة، إلا أنّه الانتباه والخوف من المؤامرات المحتملة، فلا يندفع واحد من في إحكام القبضة على مقعد الحكم حتى يطمئن للأوضاع، أو لأنّ ذلك هو المركز المنطقي الذي احتاج إليه الموضوع آنذاك، فيكون السلطان الغلام وراءًا لأبيه كترتيب منطقي، ويتولى واحد من الأمراء مسئولية البلاد.
فنجد قطز قد تحققت معه الوضعية الأخيرة، خسر كان نائبًا عن السلطان الصبي علي بن أيبك، مثلما كان نائبًا لوالده من قبل، ثم عقب هذا في إحدى المؤتمرات المتعجلة لبحث خطور المغول الذي يقارب الأطراف الحدودية المصرية، والتي كان يضطلع بـ إدارتها قطز بوصفه النائب عن السلطان، وبعد بحث الكثير من المسائل المرتبطة بالجيش، يتخذ قرار قطز جدال القضية الأخطر قائلًا: «لا مفر من سلطان قاهر يقاتل ذلك العدو، والملك الطفل ضئيل لا يحسن مخطط المملكة… فانظروا ماذا ترون».
والكل يدرك ما يود قطز قوله وأنّ موضوع توليه الحكم هي موضوع وقت، ليتم له المسألة ويصبح هو الوالي[5]، ويتولى سياقة القوات المسلحة في موقعة عين جالوت ويحقق القوات المسلحة المصرية النصر في الحرب.
توفي الملك… عاش الملك
لم يكن غريبًا في عصر الفتن أن تجد ذاك المرأى يتكرر مع الكمية الوفيرة من السلاطين، حيث يتخذ قرار أتباعه أن يتركوه وحيدًا ويغادرونه أو يبيعونه للعدو، إمّا فرًا بأنفسهم من أفعاله التي تترك تأثيرا بالسلب عليهم وعلى حياتهم، أو لأنّ مصالحهم صارت مهددة، فلا بد من البحث عن طرفٍ أحدث للوقوف معه في المستقبل.
فالعلاقة بين المماليك لم تكن لائحة على مبادئ وقيم حقيقية، بل هي مبادئ مفتعلة يحكمها مبدأ وحيد هو المنفعة والقوة، من الممكن يعتقد صاحبها أنّه يفعل الصواب حين يقف في صدام صديقه الماضي، ونستطيع أن نشاهد ذلك المرأى في حين فعله بيبرس مع قطز، حيث وقف على قدميه بإعدام صديقه عقب رجوعه من حرب عين جالوت، وصار هو الوالي الجديد للبلاد.
ولأن قاعدة «لقي حتفه الملك… عاش الملك» زوجة قاعدة «الحكم لمن غلب»، فعاجلا ما انقضت أيام قطز كأن لم تكن، لتستقبل قلعة المنطقة الجبلية سيدًا حديثًا، وحلقة عصرية في السلسلة المملوكية المرغوب لها الاستمرار حتى يحكم الله وجّهًا كان واضحًا.[7]
ولعل كل تلك المؤامرات تجعلنا نتساءل سادّا يدفع أي سلطان للاعتقاد بأنّ ما وقع مع غيره لن يتكرر معه شخصيًا، فما ظل قد عزم أن يبيع أصدقاءه، فما الذي يحظر أن يُباع هو في المستقبل؟
من الممكن يمكن تفسير الإجابة في نقطتين:
1. ظرف عدم التذكر التي تصيب الناس في الحالً في أعقاب أي حادث، وأنّهم يتبعون مبدأ «وافته المنية الملك… عاش الملك»، فيغيّرون من موقفهم بيسر تامة، وذلك ما وقع مع قطز، فمن ظرف التحضير لاستقبال البطل، إلى الإخلاص لسلطان حديث، كان ذلك هو الشأن في جمهورية مصر العربية في آنذاك، فيظن من يضطلع بـ الحكم أنّ ذلك عدم التذكر سيجعل الناس يدينون للولاء له ويبدأ عصر حديث.
2. الاعتقاد بأنّه سوف يكون قادرًا على التصرف مع الفتن والمؤامرات، وأنّه سوف يكون أذكى ممن سبقوه، فلن يحدث في نفس أخطائهم، وبذلك لن يتطلب الناس إلى الذهاب للخارج فوق منه.
وأيًا تكن العوامل، فالسلطة تعمي الإنسان وتجعله يحاول إليها، وما دام وُجدت الفتنة فلن يُسد بابها، لذا كان من المنطقي أن تتواصل المؤامرات بين المماليك إلى التتمة.
كيف اختتم حكم المماليك؟
تجابه الفرقتان خارج العاصمة المصرية القاهرة، وعاجلا ما بدأ أتباع التام شعبان يتسربون من حوله، نظر حوله غير مصدق… حتى من كانوا يتملقونه ويشاركونه شرب الراح والعربدة في الليالي الملاح باعوه لعدوه… حتى صديقه وصنيعته صاحب السمو الأمير غرلو تركه وانضم للمنقلبين فوق منه.[6]
يتألف الكتاب من 15 نصًا يذكر فيهم الكاتب وليد فكري النهايات الدامية لسلاطين المماليك أثناء مرحلة حكمهم التي امتدت من عام 1250م إلى 1517م، فكانت الخاتمة لآخر سلطان مملوكي وهو «طومان باي»، والذي تم إعدامه عن طريق العثمانيين لدى باب زويلة.
وتبدأ في تلك اللحظة مدة حديثة في الحكم المصري، الفترة التي يصفها الكاتب بأنّها «الانتزاع العثماني لمصر»، حيث لم ترَ جمهورية مصر العربية الخير أثناءها، وتوقفت عن أي منجزات أو إسهامات في الفن وغيرها من النشاطات.
من المحتمل كانت مدة حكم المماليك معبأة بالعديد من المؤامرات والصراعات والفتن، أدرك لم يكونوا ملائكة، إلا أنّهم أيضًا لم يكونوا شياطين، وقد نجحوا في تقديم ميراث حضاري ضخم، وتركوا أثر طرف إصبع في المصلحة والحكم.
والدرس المستفاد من ذلك الشيء، هو أن نتعلّم أن قراءة الزمان الماضي والحكم على الدول، لا يلزم أن تكون عن طريق النظرة المطلقة، فكل جمهورية من الممكن أن يكون لها مميزاتها وعيوبها، نحن نفتقر إلى بحث المسألة طول الوقتً بالكيفية السليمة، حتى ندرك ذلك الشأن، والشيء المؤكد إجراءًا عن مرحلة حكم المماليك أنّها كانت «جمهورية ذات أثر طرف إصبع»[8]، وأن خيط الدم فيها امتد من اللحظة الأولى للأخيرة، فكأنّ القتل في في حينها قد أمسى أسلوب حياة.