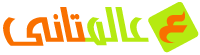في مدينة المنيا ولدت انشراح علي موسى عام ١٩٣٧ لأسرة متوسطة الحال .. وبرغم التقاليد المتزمتة في ذلك الوقت دخلت الفتاة الصعيدية المدرسة وواصلت تعليمها حتى حصلت على الشهادة الاعدادية عام ١٩٥١.
وبعد نجاحها بأيام قليلة أراد والدها مكافأتها فاصطحبها معه إلى القاهرة لحضور حفل عرس أحد أقاربه.
و في حفل العرس تعرفت علي زوجها المستقبلي إبراهيم سعيد شاهين ابن العريش المولود عام ١٩٢٩ الذي ما غادر الحفل إلا و عرف عنها كل شيء وبعد أيام قلائل فوجئت به يطرق باب بيتها في المنيا برفقته والده طارت انشراح من السعادة وحلقت بين السحب بخيالها تستطلع مستقبلها الهنيء
وانزعجت الفتاة الصغيرة عندما اعترضت والدتها في أمر زواجها منه متعلله ببعد المسافة بين المنيا والعريش وبكت بحرقة وهي ترى أحلامها الوردية تكاد أن تحقق ثم سرعان ما تنهار في ذات الوقت دون أن تقدر على عمل شيء
إلا ان ابيها كان له رأي مخالف ووافق علي إتمام الزيجه و سرعان ما أعلنت الخطبة..
وفي أول حديث مع خطيبها صارحته بأنها أعجبت به مذ ان رأته في حفل القاهرة وازداد إعجابها به حينما سعى وراءها حتى المنيا ليطلب يدها.
وفي حفل بسيط انتقلت انشراح إلى بيت الزوجية في العريش مع زوجها ابراهيم
كان إبراهيم شاهين يعمل كاتب حسابات بمكتب مديرية العمل بالعريش وهو أيضاً لم يحصل سوى على الإعدادية مثلها لذلك اتفق وانشراح على أن يواصل أولادهما تعليمهم حتى أعلى الشهادات العلميّة وأصبح هذا الأمل هو هدفهما الذي يسعيان اليه ويعملان على تحقيقه مهما كانت الظّروف
في أواخر عام ١٩٥٥ زرقا بمولدهما الأول “نبيل”… ثم جاء المولود الثاني محمد عام ١٩٥٦، ثم عادل في ١٩٥٨
وفي عام ١٩٦٣ – وكما اتفقا من قبل – أرسلا بأولادهما إلى عمهم بالقاهرة ليواصلوا الدراسة هناك وليعيشوا حياة رغدة بعيداً عن مظاهرة البداوة وظروف الحياة الأقل حظاً من العاصمة.. وفي أكتوبر ١٩٦٦ ضبط إبراهيم يتلقى الرشوة وحبس ثلاثة أشهر خرج بعدها ليكتشف مدى قسوة الظروف التي تمر به والمعاناة الشديدة في السعي نحو تحقيق آماله في الارتقاء والثراء.
في يونيو ١٩٦٧ اجتاحت إسرائيل سيناء واحتلتها و أغلقت فجأة أبواب السبل أمام السفر إلى القاهرة فتأزمت انشراح نفسياً قلقاً على أولادها
هكذا ظلت انشراح تبكي معظم الليل والنهار و وجد إبراهيم أن الحياة في العريش كما لو كانت في الأسر فالحزن يخيم على البيت والمعيشة أضحت في أسوأ حال فمنذ الغزو وهو عاطل عن العمل لا يملك المال الذي يشتري به أبسط الأشياء
وسط هذا المناخ كانت المخابرات الإسرائيلية تعمل بنشاط زائد و تسعى لتصيد العملاء بسبب الضغوط المعيشية الصعبة وظروف الاحتلال… فالاحتلال الفجائي لسيناء وقع على سكانها كالصاعقة، فاختنقت نفوس الأهالي برغم اتساع مساحات الأرض والجبال… ولكونهم ذوي تقاليد بدوية ومحبين للحركة والتجوال والتنقل، أحسوا بثقل الأمر ولم يطيقونه … لكن الظروف التي وضعوا فيها اضطرتهم إلى محاولة تحملها لثقتهم أنها أزمة لن تطول. لكن ما كان يحز في نفوسهم هو تضييق الخناق عليهم في المعيشة والتنقل.. فكانت التصاريح التي يمنحها الحاكم العسكري الإسرائيلي لا تتم بسهولة… وأصبح السفر إلى القاهرة يحتاج لمعجزة من السماء. فالتعنت في منح التصاريح بلغ منتهاه.. واشتدت عضات الغضب في الصدور.. إلى جانب آلام الجوع التي تنهش الأبدان وتجتث الصبر والقوة.
ضاقت الحياة باتساعها على إبراهيم وانشراح في العريش.. وخلا البيت من الطعام والشراب والسرور… وخيمت قتامة سوداوية على نفسيهما… فازدادا يأساً وشوقاً إلى الأبناء في العاصمة.. وأمام البكاء المستمر الذي تورمت له عينا انشراح… اندفع ابراهيم إلى مكتب الحاكم العسكري يطلب تصريحاً له ولزوجته بالسفر إلى القاهرة.
ولما ماطلوه كثيراً بوعود كاذبة .. صرخ في وجه الضابط الاسرائيلي قائلاً إنه فقد عمله ودخله ولا يملك قوت يومه… فطمأنه الضابط “أبو نعيم” ووعده بالنظر في أمر التصريح في أسرع وقت… وبعد حديث طويل بينهما حاول ابراهيم خلاله التقرب اليه لإنجاز التصريح… أمر له أبو نعيم بجوال من الدقيق وبعض أكياس الشاي والسكر… فحملها فرحاً إلى زوجته وهو يزف اليها السفر إلى القاهرة عما قريب.
استبشرت انشراح خيراً وغمرتها السعادة بما جاءها به، وغاصت في أحلامها وتخيلاتها باللقاء الحميم مع فلذات أكبادها. لكن الأيام تمر وأبو نعيم يعد ولا ينفذ .. ويعود إبراهيم في كل مرة محبطاً… لكنه كان يحمل معه دائماً أكياس المواد التموينية التي أصبحت هي المصدر الوحيد للإعاشة.. ولولاها لمات جوعاً هو وزوجته.
وذات صباح فوجئ بمن يستدعيه لمكتب أبو نعيم.. فذهب اليه في الحال وقدم له الشكر على الإعانة الدورية التي يمنحها له.. فأخبره الضابط بأن الحاكم العسكي وافق على منحه تصريح السفر هو وزوجته..
تهلل وجه ابراهيم بشراً وقبل ظهر يده شكراً لله.. فباغته أبو نعيم وقال له بأن موافقة الحاكم العسكري جاءت بشرط أن يكون متعاوناً ويأتيه بأسعار الفاكهة والخضروات في مصر.. والحالة الاقتصادية للبلد بواسطة أخيه الذي يعمل بالاستيراد والتصدير.
أجاب إبراهيم على الفور أن الشرط بسيط للغاية… فبإمكانه القيام بهذه المسألة خير قيام… وأضاف بأنه سيأتيهم بأسعار السلع الاستهلاكية والبقالة والسمك أيضاً.. ولو أنهم أرادوا أكثر من ذلك لفعل.
عندئذ.. وضحت الرؤية للضابط الإسرائيلي.. فقد نجح ابراهيم شاهين في الاختبار الأول.. وكان عليه أن يتصرف معه حسبما هو متبع.. ويحيله إلى الضابط المختص لإكمال المهمة.. فدوره ينحصر فقط في “الفرز” لا أكثر.
وبينما ابراهيم وانشراح يحتفلان بالأمل الجديد الذي راودهما طويلاً.. توقفت سيارة جيب أمام المنزل، وطلب منه جندي أن يرافقه إلى مكتب الأمن… وهناك كان ينتظره ضابط يدعى “أبو يعقوب” بالغ في الاحتفاء به بدعوى أن أبا نعيم أوصاه به خيراً. فشكره ابراهيم وأثنى على أبو نعيم وامتد بينهما الحوار لوقت طويل… استشف أبو يعقوب بحاسته أن ابراهيم يدرك ما يبتغيه منه.. فطلب منه أن يذهب معه إلى بئر سبع .. حيث المكتب الرئيسي للأمن المختص بالتعامل مع أبناء سيناء.
وفي بئر سبع استضافوه وأكرموه بكل السبل، ولوحوا له بإغراءات ما كان يحلم بمثلها يوماً… نظير إغراقه بالنقود وتأمين حياته وذويه في العريش وافق إبراهيم على التعاون مع الإسرائيليين في جمع المعلومات عن مصر.. وتسلم – كدفعة أولى – ألف دولار في الوقت الذي لم يكن يملك فيه ثمن علبة سجائر.
لم تكن تلك الإغراءات أو التهديدات المغلفة هي وحدها السبب الأول في سقوطه.. لكن تشريح شخصيته يعطينا مؤشراً عن استعداده الفطري للخيانة.. فلا يمكن لشخص سويّ أن يستسهل بيع نفسه ووطنه هكذا بسهولة.. لمجرد منفعة مادية مؤقتة.. فالمؤكد أن خلايا الخيانة كانت قابعة بين أنسجته منذ ولادته… وكان يجاهد كثيراً حتى وجد لها منفذاً فأخرجها.
ففي بئر سبع تغير المشهد.. إذ تحول ابراهيم شاهين من مواطن يسعى للحصول على تصريح بالسفر إلى القاهرة .. إلى جاسوس لإسرائيل وعيناً لها على وطنه.
تناقض شاسع بين الحالين يدعونا للبحث في تقلبات النفس البشرية التي لا يعلم سرها إلا خالقها..
أخضع الجاسوس الجديد لدورة تدريبية مكثفة تعلم أثناءها الكتابة بالحبر السري وتظهير الرسائل.. ووسائل جمع المعلومات من الأهل والأصدقاء… درب أيضاً على كيفية التمييز بين الطائرات والأسلحة المختلفة.. واجتاز العميل الدورة بنجاح أذهل مدربيه… فأثنوا عليه ووعدوه بالثراء وبالمستقبل الرائع… وبحمايته في القاهرة حتى وهو بين ذويه … فعيونهم في كل مكان لا تكل ولقنوه شكل الاستجواب الذي سيتعرض له حال وصوله القاهرة من قبل أجهزة الأمن، وكيف ستكون إجاباته التي لا تثير الشكوك من حوله.
وعندما رجع إلى بيته محملاً بالهدايا لزوجته وأولاده… دهشت انشراح وسألته عن مصدر النقود .. فهمس لها بأنه أرشد اليهود عن مخبأ فدائي مصري فكافأوه بألف دولار… ووعدوه بمنحه التصريح خلال أيام.
بهتت الزوجة البائسة لأول وهلة .. ثم سرعان ما عانقت زوجها سعيدة بما جلبه لها .. وقالت له في امتنان: كانوا سيمسكونه لا محالة … إن عاجلاً أم آجلاً…
فسألها في خبث: ألا يعد ذلك خيانة .. ؟
فغرت فاها وارتفع حاجباها في استنكار ودهشة وأجابته: مستحيل … كان غيرك سيبلغ عنه ويأخذ الألف دولار… أنت ما فعلت إلا الصح.
غمغم ابراهيم كأنه مستاء مما فعل وأضاف: لقد عاملوني بكرم شديد… ووعدوني بالكثير بسبب إخلاصي.. وتعهدوا بحماية أهلي وأقاربي إذا ما تعاونت معهم في القاهرة …
صرخت انشراح في هلع: تعاونت معهم في القاهرة .. ؟ يانهار اسود يا ابراهيم .. كيف .. ؟
وهي يغلق فمها بيده: طلبوا مني موافاتهم بأسعار الخضر والفاكهة في مصر نظير ٢٠٠ دولار لكل خطاب. أذهلها المبلغ فسرحت بخيالها وألجمها الصمت ثم قالت له فيما يشبه الهمس: أنا خائفة.
فأجابها : أنا لا أملك عملاً الآن وليس لي مورد رزق… وبالمعلومات التافهة التي طلبوها سآخذ الكثير وسنعيش في مأمن من الفقر… ثم إنني لست عسكرياً حتى أخاف على نفسي… ولأنني رجل مدني فمعلوماتي ستكون هزيلة ولن تفيدهم بشيء.
في ١٩ نوفمبر ١٩٦٧ وصل ابراهيم وانشراح إلى القاهرة بواسطة الصليب الأحمر الدولي .. فمنح سكناً مجانياً مؤقتاً في حي المطرية .. ثم أعيد إلى وظيفته من جديد بعدما نقلت محافظة سيناء مكاتبها من العريش إلى القاهرة.
وبعدما استقرت الأمور قليلاً… انتقل ابراهيم إلى حي الأميرية المزدحم .. ومن خلال المحيطين به في العمل والمسكن …بدأ في جمع المعلومات وتصنيفها.. وكانت زوجته تساعده بتهيئة الجو الآمن لكتابة رسائله بالحبر السري.. وكثيراً ما كانت تعيد صياغة بعض الجمل بأسلوب أفضل .. وتكتب أيضاً تحياتها إلى الموساد على أنها شريكة في العمل… واعتاد ابراهيم أن يختتم رسائله بعبارة: “تحيا اسرائيل العظمى …موسى”.
ولأجل التغطية اتجه إلى تجارة الملابس والأدوات الكهربائية .. وبواسطة المال والهدايا كان يتغيب كثيراً عن العمل غالبية أيام الأسبوع، ولشهور عديدة تواصلت الرسائل إلى روما مزدحمة بالأخبار .. مما حدا برجال الموساد إلى دعوته إلى روما لاستثمار هذا الثنائي الرائع في مهام أكثر أهمية ..
وفي أغسطس ١٩٦٨ وتحت ستار التجارة لا أكثر … أبحر الثعبان والحية إلى لبنان… ومنها طارا إلى روما حيث التقيا بمندوب الموساد الذي سلمهما وثيقتي سفر إسرائيليتين باسم موسى عمر ودينا عمر .. وعلى طائرة شركة العال الاسرائيلية طارا إلى مطار اللد…
كان استقبالهما في إسرائيل بالغ الحفاوة والترحيب … إذ عوملا معاملة كبار الزوار… وأنزلا بفيلا خيالية في تل أبيب مكثا بها ثمانية أيام .. حصلا خلالها على دورة تدريبية مكثفة في تحديد أنواع الطائرات والأسلحة .. والتصوير الفوتوغرافي.. وجمع المعلومات .. ومنح ابراهيم رتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي باسم موسى . أما انشراح فقد منحت رتبة ملازم أول باسم دينا.
وفي مقابلة مع أحد القيادات العليا في الموساد .. أكدت إنشراح على ضرورة زيادة المكافآت لاشتراكها في العمل يداً بيد مع ابراهيم… ووصفت له صعوبة جمع المعلومات ما لم يشتركا معاً في جمعها وتصنيفها .. وأفاضت في سرد العديد من الحيل التي تقوم بها لانتزاع المعلومات من العسكريين الذين صادقهم زوجها ويجيئون لمنزلهم..
ونظراً لأهمية المعلومات التي حصلوا عليها من خلال الجاسوس وزوجته… فقد قرروا لهما مكافأة سخية وأغدقوا عليهما بآلاف الدولارات التي عادا بها إلى القاهرة .. حيث استغلا وجودهما وسط حي شعبي فقير في عمل الصداقات مع ذوي المراكز الحساسة من سكان الحي… وإرسال كل ما يصل إليهما من معلومات إلى الموساد فوراً..
لقد برعا خلال حرب الاستنزاف – ١٩٦٧ – ١٩٧٠ – في التحليل والتصنيف، وتصوير المنشآت العسكرية أثناء رحلات للأسرة بالسيارة الجديدة فيات ١٢٤.
يقول الابن الأصغر عادل في حديث نشرته جريدة معاريف الإسرائيلية عام ١٩٩٧:
“لن أنسى ذلك اليوم الملعون من صيف ١٩٦٩ طيلة حياتي … فقد استيقظت مبكراً على صوت همسات تنبعث من حجرة نوم والدي… كان أبي وأمي مستغرقين في نقاش غريب…وكانت أمي تمسك في يدها حقيبة جلدية بينما كان أبي يحاول إدخال كاميرا إلى داخلها لم أر مثلها من قبل في ذلك الحين، كانت أمي غاية في العصبية وقالت له: لا ليس كذلك… هكذا سيرون الكاميرا. فأخرج أبي الكاميرا وأدخلها مرات ومرات إلى الحقيبة.. فجلست أنظر اليهما وهما يتناقشان … ثم قال لي أبي: نحن ذاهبون إلى رحلة إلى الاسكندرية.
كان الوالد والوالدة غاية في القلق… ولم أرهما متوترين إلى هذا الحد من قبل، أخذ أبي يتصبب عرقاً كلما ابتعدنا عن القاهرة، إلى أن بلل قميصه تماماً كلما ابعتدنا أكثر فأكثر من القاهرة. وكان يتبادل الكلمات مع أمي بصعوبة، وصمتنا نحن أيضاً لشعورنا أن هذه الرحلة ليست ككل رحلة. وفي تلك الفترة كانت هناك قواعد عسكرية ومصانع حربية كثيرة متناثرة حول الطرق الرئيسية في مصر. لم تخف السلطات شيئاً. ربما كنوع من استعراض القوة. وعندما بدأنا في الاقتراب من إحدى القواعد العسكرية أخرجت أمي الكاميرا وأمرها أبي قائلاً: “صوري . ياللا صوري … صوري”. فقالت له وأصابعها ترتعش: “سنذهب إلى الجحيم بسببك”. وحركت أمي الجاكيت المعلق على النافذة وبدأت في التصوير، وامتلأت السيارة الصغيرة بصرخاتها الممزوجة بالخوف. فأجابها أبي بنفس اللهجة: “هذه نهايتنا”. واستمرت أمي في احتجاجها قائلة: “سنذهب إلى السجن”. وفي النهاية نظر أبي اليها بعيون متوسلة: “عدة صور أخرى… فقط عدة صور أخرى”.
وحاول “محمد” أن يسأل ما الذي يحدث لكن الرد الذي تلقاه كان “اسكت” فلم نسأل أية أسئلة أخرى بعد ذلك.
عدنا للبيت إلى في ذلك اليوم. وعلى الفور أغلق أبي حجرته على نفسه وبعد فترة طويلة خرج وعانق أمي وقال لها: “يا حبيبتي لقد قمت بالتقاط صور رائعة للغاية”. وبكت أمي وقالت له: “إلى هنا يجب أن نشرح الأمر للأولاد”. وكنا ما زلنا في صدمة وغير مدركين لهذه الجلبة التي تحدث.
وتحولت الرحلات الأسرية في أنحاء مصر إلى روتين… وكنا نخرج في نهاية كل أسبوع وكنا نسافر إلى الأقصر، وأسوان، ليس هناك مكان لم نذهب إليه.. وأحياناً كان أبي يحصل على إجازة في وسط الأسبوع وكنا نسافر لعدة أيام… وقد صورت قواعد ومنشآت عسكرية في مصر… وكان أبي يسجل عدد الكيلو مترات في الطريق… وبذلك يحدد موقع المصانع والقواعد العسكرية… وكنا نحن الأولاد أفضل تغطية”
تعددت زيارات ابراهيم وانشراح إلى روما… بعضها كان باستدعاء من الموساد.. والبعض الآخر كانت لاستثمار عشرات الآلاف من الدولارات التي حصلوا عليها من جراء عملهما في التجسس.
وفي إحدى هذه الزيارات.. قررا إشراك ولديهما لزيادة الدخل بتوسع حجم النشاط… ولم يكن من الصعب عليهما تنفيذ ما اتفقا عليه..
يقول الابن عادل في حديثه المنشور بجريدة معاريف: “عاد أبي وأمي ذات مساء من روما يحملان لنا الملابس الأنيقة والهدايا… وأحسست من خلال نظراتهما لبعضيهما أن هناك أمراً ما يجري الترتيب له وعرفت الحقيقة المرة عندما أجلسني أبي قبالته أنا وأخويّ وقال في حسم:
مررنا كثيراً بظروف سيئة.. لم نكن نملك أثناءها ثمن رغيف الخبز.. أو حفنة من الملح.. والآن نعيش جميعاً في رغد من العيش… ويسكن حوالينا أولاد في عمركم يحيون جوعى كالعبيد… أما أنتم فتنعمون بكل شيء كالملوك. ولم تسألوني يوماً من أين جئت بكل هذا.. ؟
إن عملي في الحكومة .. وتجارتي أنا وأمكن وشقائي طوال تلك السنوات لم يكن هو سبب النعيم الذي نحن جميعاً الآن… والحقيقة .. أن هناك أناساً يحبوننا للغاية.. وهم هؤلاء الذين يرسلون لنا الهدايا والمال… وبفضلهم لدينا طعام طيب وملابس جميلة.. إنهم الاسرائيليون… وهم الذين أنقذوا حياتنا من الجوع والضياع… وأمنوا لنا مستقبلاً مضموناً يحسدنا عليه كل من نعرفهم.
حدث ذلك في صيف ١٩٧١، وكنت وقتها في الثالثة عشر من عمري، وكان أخي نبيل يكبرني بعامين تقريباً وأخي محمد بعام واحد.
وكطفل … لم أعر الأمر أهمية خاصة … لحقيقة أن أبي “يعمل” مع الاسرائيليين.. ومثل كل الأولاد… كنت قد كبرت وتربيت على كراهية اليهود… لكن في البيت تلقيت تربية أخرى … فقد عرفت أن الاسرائيليين هم المسؤولون عن الطعام الذي آكله… وعن الملابس الجديدة التي أرتديها… وعن الهدايا التي أتلقاها… لذلك .. سعدت لأنني كنت محظوظاً.
وكلما كبرت .. بدأت أدرك معنى “عمل” أبي .. وبدأ الخوف ينخر أكثر وأكثر في عظامي… فقد كانت كماشة من الموت تطبق علينا… وكفتى بالغ أدركت أنهم لو ضبطونا سيتم شنقنا.. من ناحية أخرى كان الخوف من حياة الفقر يصيبني بالشلل… فقد كنت ملكاً لديه كل شيء”.
هكذا انخرطت الأسرة كلها في التجسس… وأصرت انشراح على الانتقال من الحي الشعبي الفقير إلى آخر رقياً وثراء… وعندما عارض زوجها قالت له: دعنا نستمتع بالحياة فربما ضبطونا.
وفي النهاية انتقلوا إلى فيلا فاخرة بمدينة نصر.. ونقل نبيل ومحمد وعادل مدارسهم إلى الحي الراقي الجديد.
احتفظ ابراهيم شاهين بعلاقاته القديمة وأقام أخرى جديدة… وامتلأ البيت مرة أخرى بالأصدقاء من رجال الجيش والطيارين… وتحول أولاده إلى جواسيس صغار يتنافسون على جلب المعلومات من زملائهم أبناء الضباط في المدرسة والشارع… ومناوبة الحراسة ريثما ينتهي أباهم من تحميض الأفلام… فكان نبيل يتولى المراقبة من الخارج… وعادل من داخل البيت … وحصل نبيل على أدوار أكثر جدية.. فكان أبوه يسمح له بكتابة الرسائل بالحبر السري وتظهيرها… وصياغة التقارير وتحميض الصور.
وذات مساء بينما هم جميعاً أمام التليفزيون … عرض فجأة فيلم تسجيلي عن أحد الجواسيس الذي انتهى الأمر بإعدامه شنقاً.. وطوال وقت عرض الفيلم انتابتهم حالة صمت تضج بالرعب والفزع… واستمروا على تلك الحال لأسابيع طويلة.. امتنعوا خلالها عن كتابة التقارير أو الرسائل… حتى تضخم لديهم الخوف وأصيبوا بالصداع المستمر.. ومرض ابراهيم فاضطرت انشراح للسفر وحدها إلى روما تحمل العديد من الأفلام… خبأتها داخل مشغولات خشبية.
كانت الرحلة إلى روما منفثاً ضرورياً للخروج من أزمتها النفسية السيئة.. وفي الوقت نفسه لتطلب من رجال الموساد السماح لهم بالتوقف عن العمل… فلما التقت بأبو يعقوب ضابط الموساد الداهية… قصت عليه معاناتهم جميعاً ومدى الخوف الذي يسيطر على أعصابهم.. فطمأنها الضابط ووعدها بعرض الأمر على الرئاسة في تل أبيب.. بعدها عادت إلى القاهرة تحمل آلاف الدولارات.
وفي آخر سبتمبر ١٩٧٣ كانت انشراح بمفردها في رحلة أخرى من رحلتها المعتادة إلى روما .. فاستقبلها أبو يعقوب المسؤول عن توجييها واستلام التقارير والأفلام منها. حتى فاجأها أبو يعقوب في أكتوبر بنبأ هجوم الجيش المصري والسوري على إسرائيل… وأن احتمال القضاء على دولة اليهود أصبح وشيطاً. كان يقول لها ذلك وهو يبكي ويرتعد جسده انفعالاً.. فأخذت تواسيه وتبكي لأجله ولأجل إسرائيل… الدولة الصغيرة التي يسعى العرب لتدميرها .
وفي أبريل ١٩٧٤ اقترحت إنشراح على أسرتها السفر إلى تركيا للسياحة.. وبينما هم في أنقرة اتصل بهم أبو يعقوب وطلب من ابراهيم أن يسافر إلى أثينا لمقابلته. ومن هناك سافر إلى إسرائيل. وفي مبنى المخابرات الاسرائيلية سألوه:
كيف لم تتبين الاستعدادات للحرب في مصر؟ فأجابهم: لم يكن هناك إنسان قط يستطيع أن يتبين أية استعدادات. فبعض معارفي وأقاربي من ضباط القوات المسلحة تقدموا بطلبات لزيارة الكعبة للعمرة.
وأضاف ابراهيم:
في حالة ما إذا كنت قد علمت بنية الحرب فكيف أتصل بكم …؟ فالخطابات تأخذ وقتاً طويلاً وهي وسيلة الاتصال الوحيدة المتاحة.
وبعد اجتماع مطول قرر قادة الموساد تسليم إبراهيم أحدث جهاز إرسال لاسلكي في العالم يتعدى ثمنه المائة ألف دولار. فلقد كانت لديهم مخاوف تجاه الفريق سعد الدين الشاذلي الذي يريد تصعيد الحرب… والوصول إلى أبعد مدى في سيناء مهما كانت النتائج… عكس السادات الذي كان يريدها حرباً محدودة.
دُرب إبراهيم لمدة ثلاثة أيام على كيفية استخدام الجهاز… وعندما تخوف من حمله معه إلى القاهرة.. عرضوا عليه أن يذهب إلى الكيلو ١٠٨ طريق القاهرة السويس الصحراوي. وهناك سيجد فنطاس مياه كبيرة مثقوب وغير صالح للاستخدام… وخلفه جدار أسمنتي مهدم عليه أن يحفر في منتصفه لمسافة نصف المتر ليجد الجهاز مدفوناً. وأخبره ضابط الموساد الكبير أن راتبه قد تضاعف، وأن له مكافأة مليون دولار إذا ما أرسل للإسرائيليين عن يقين بميعاد حرب قادمة.
عاد إبراهيم إلى أثينا ثم أنقره حيث تنتظره الأسرة… فقضوا أوقاتاً جميلة يستمتعون بالمال الحرام وبثمن خيانتهم.
عقب عودتهم إلى القاهرة استقلوا السيارة إلى الكيلو ١٠٨ وغادرت انشراح السيارة وبيدها معول صغير…وظلت تحفر إلى أن أخرجت الجهاز… فنادت على ابنها عادل الذي عاونها وحمله إلى السيارة ملفوفاً في عدة أكياس بلاستيكية… وعندما ذهبوا بالجهاز إلى المنزل أراد ابراهيم تجربته بإرسال أولى برقياته فلم يتمكن من إكمال رسالته.. بعدما تبين له أن مفتاح التشغيل أصيب بعطل (ربما نتيجة الحفر بالمعول).
حزن الجميع… لكن انشراح عرضت السفر لإسرائيل لإحضار مفتاح جديد.. وسافرت بالفعل يوم ٢٦ يوليو ١٩٧٤ ففوجئ بها أبو يعقوب ودهش لجرأتها… ومنحها مكافأة لها ٢٥٠٠ دولار مع زيادة الراتب للمرة الثالثة إلى ١٥٠٠ دولار شهرياً
وأثناء وجود انشراح في إسرائيل بين جدران الموساد، كانت هناك مفاجأة خطيرة تنتظرها في القاهرة فعندما كان ابراهيم يحاول إرسال أولى برقياته إلى إسرائيل بواسطة الجهاز – استطاعت المخابرات المصرية التقاط ذبذبات الجهاز بواسطة اختراع سوفييتي متطور جداً اسمه (صائد الموجات) وقامت القوات بتمشيط المنطقة بالكامل بحثاً عن هذا الجاسوس. ومع محاولة تجربة الجهاز للمرة الثانية أمكن الوصول لإبراهيم بسهولة.
وفي فجر ٥ أغسطس ١٩٧٤ كانت قوة من جهاز المخابرات المصرية تقف على رأس ابراهيم النائم في سريره. استيقظ مذعوراً وفي الحال دون أن توجه إليه كلمة واحدة في هلع:
أنا غلطان … أنا ندمان .. الجوع كان السبب … النكسة كانت السبب… اليهود جوعوني واشتروني بالدقيق والشاي.
ولما فتشوا البيت عثروا على جهاز اللاسلكي ونوتة الشفرة… والتزم ابراهيم الصمت… وكان بدنه كله يرتجف… سحبوه في هدوء للتحقيق معه في مبنى المخابرات العامة، بينما بقيت قوة من رجال المخابرات في المنزل مع أولاده الثلاثة تنتظر وصول انشراح، تأكل وتشرب وتنام دون أن يحس بهم أحد.
وعلى طائرة ايطاليا رحلة ٧٩١ في ٢٤ أغسطس ١٩٧٤، وصلت انشراح إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من روما بعد شهر كامل بعيداً عن مصر، تدفع أمامها عربة تزدحم بحقائب الملابس والهدايا، ونظرت حولها تبحث عن زوجها فلم تجده، فاستقلت تاكسياً إلى المنزل وهي في قمة الغيظ… وعندما همت بفتح الباب اقشعر جسدها فجأة، فدفعت بالباب لا تكترث… لكنها وقفت بلا حراك… وبالت على نفسها عندما تقدم أحدهم… وأمسك بحقيبة يدها وأخرج منها مفتاحين للجهاز اللاسلكي بدلاً من مفتاح واحد. وكانت بالحقيبة عدة آلاف من الدولارات دسها الضابط كما كانت .. وتناول القيد الحديدي من زميله وانخرست الكلمات على لسانها فكانت تتمتم وتهذي بكلمات غير مفهومة … وقادوها مع ولديها إلى مبنى المخابرات وهناك جرى التحقيق مع الأسرة كلها.
ولما كانت المخابرات الإسرائيلية لا تعلم بأمر القبض على أسرة الجواسيس… وتنتظر في ذات الوقت الرسالة التي سيبعث بها ابراهيم ليطمئنوا على كفاءة عمل الجهاز … فوجئت الموساد بالرسالة.. لم تكن بالطبع من ابراهيم بل أرسلتها المخابرات المصرية.
“أوقفوا رسائلكم مساء كل أحد… لقد سقط جاسوسكم وزوجته وأولاده، وقد وصلتنا آخر رسائلكم بالجهاز في الساعة السابعة مساء الأربعاء الماضي”.
وفي ٢٥ نوفمبر ١٩٧٤ صدر الحكم بإعدام انشراح وزوجها شنقاً، والسجن ٥ سنوات للابن نبيل وتحويل محمد وعادل لمحكمة الأحداث.
وفي ١٦ يناير ١٩٧٧ سيق ابراهيم إلى سجن الاستئناف بالقاهرة لتنفيذ الحكم، كان لا يقو على المشي… وإلى حجرة الاعدام كان يجره اثنان من الجنود وساقاه تزحفان خلفه بينما هو يضحك في هستيريا ثم يبكي… وبعدما تيقن من أنه سوف يُعدم أخذ يردد آيات من القرآن الكريم بكلمات غير مفهومة ثم صاح في انهيار: سامحني يا رب… وتلا عليه مأمور السجن منطوق الحكم .. ثم ردد الشهادتين وراء واعظ السجن … عندئذ عرضوا عليه آخر طلب له قبل إعدامه فطلب سيجارة.. وبعد أن انتهى من تدخينها جروه جراً إلى داخل غرفة الإعدام … فقام عشماوي بتقييد يديه خلف ظهره… ثم ألبسه الكيس الأسود ووضع الحبل في رقبته … وشد ذراعاً… وظل الجسد معلقاً في الهواء يتأرجح إلى أن همد وسكن… واستمر النبض ثلاث دقائق وعشر ثوان بعد التنفيذ … حتى أعلن طبيب السجن وفاة الجاسوس الذي ظل يتعامل مع الموساد طوال سبع سنوات.
أما انشراح فقد ترددت الأنباء في حينها عن شنقها هي الأخرى .. ولكن في ٢٦ نوفمبر ١٩٨٩ نشرت صحيفة “حداشوت” الاسرائيلية قصة تجسس ابراهيم على صفحاتها الأولى … وذكرت الصحيفة أن ضغوطاً مورست على الرئيس السادات لتأجيل إعدام انشراح بأمر شخصي منه… ثم أصدر بعد ذلك عفواً رئاسياً عنها .. وتمكنت انشراح (في صفقة لم تعلن عن تفاصيلها) من دخول اسرائيل مع أولادها الثلاثة… حيث حصلوا جميعاً على الجنسية الاسرائلية واعتنقوا الديانة اليهودية.. وبدلوا اسم شاهين إلى (بن ديفيد) واسم انشراح إلى (دينا بن ديفيد) وعادل إلى (رافي) ونبيل إلى (يوسي) ومحمد إلى (حاييم) … !!!
وعن اللحظات الأخيرة التي وضعت نهاية أسرة الجواسيس… يقول أصغر الأبناء – عادل – في حديثه لصحيفة معاريف الاسرائيلية :
بعد حرب ٧٣ قرر والدي نهائياً أن تكون هذه هي السنة الأخيرة لهم في أعمال التجسس. وكانت الخطة تقضي ببيع البيت والممتلكات والسفر للولايات المتحدة .. وأنا كفتى في الخامسة عشرة من عمره آنذاك فكرت قطعاً في المستقبل .. ووعدني والدي بإرسالي للدراسة في أفضل كلية هناك. وبعد ان اتخذوا قراراً بأن تكون هذه هي السنة الأخيرة لنا في مصر شعرنا أننا أكثر راحة وأزيح حجر ثقيل من على صدورنا. لكن كان هناك حادثان في تلك السنة هزا ثقتنا. فقد أراد والدي تجنيد شقيقه أيضاً. وأتذكر النقاشات التي دارت بين أمي وأبي حول ذلك… فقد خافت أمي من أن يسلمنا شقيق والدي .. وحتى اليوم لست أعرف هل عرف بذلك الأمر أم لا؟. والحادث الآخر كان بعد الحرب عندما قمنا بزيارة الأخوال .. وتشاجرت شقيقة أمي “فتحية” مع ابنتها نجوى… وكانت هناك صرخات عالية في البيت وحاول أبي التدخل… فأغلقت نجوى باب دورة المياة عليها وصرخت في أبي:
“لماذا تتدخل؟ فالجميع يعرف أنك تعمل مع الاسرائيليين”.
فدخل أبي وراءها وصفعها، وحتى اليوم لا أعرف من أين عرفت … وشعرنا أن الأمور خرجت عن السيطرة. وفي إحدى المرات التي سافرت فيها أمي إلى روما كي تحصل على قطع غيار لجهاز البث الذي عطب .. عاد أبي من العمل شاحباً، وجلس على أحد المقاعد ونظر لي وهمس:
“أعتقد أنهم قد تمكنوا مني”. وصمتنا ، وأضاف: “لقد سألوا عني في العمل”.
فبعد سبع سنوات من التجسس كان لأبي حواس حادة، وعندما قال لنا أنهم قد تمكنوا منه كان قد عرف ذلك عن يقين، كان لدينا في البيت حوالي 6 شرائط أفلام، وبدأ أبي في تمزيقها وحرقها وحرق الخطابات… وأدركنا أن الحكاية قد انتهت… وحتى اليوم لست أدري لماذا لم يأخذنا أبي ويهرب ولماذا لم نطلب منه الهرب؟! وأنا أسترجع تلك الأيام في مخي حتى اليوم لا أفهم لماذا ظللنا في البيت؟. وفي صباح أحد الأيام استيقظنا على صوت طرقات قوية على الباب، وفي المدخل وقف ثلاثة من الرجال وسألوا أين أبي؟ فقلت لهم إنه في العمل، فدخلوا وطلبوا انتظاره. جلس اثنان منهم في الصالون والآخر أخذ مقعداً وجلس بجانب الباب… وقلت له:
“سيدي من فضلك أدخل إلى الصالون”.
فأجابني قائلاً: “أشعر بالراحة هنا”. فتبادلت أنا وأخي نظرات فزعة، وحاول نبيل الدخول إلى حجرة أبي كي يدمر الوثائق التي كانت هناك … لكن الأدراج كانت مقفلة وكانت المفاتيح مع أبي، فتبادلنا نظرات يائسة ولم نعرف ما يمكن أن نفعله، مرت ساعة بدت كأنها الدهر ثم سمعنا أصوات سيارات. واقترب من البيت موكب يتكون من عشر سيارات وكانت سيارة أبي تسير ببطء في المنتصف، وتوقفوا أمام المنزل، واقتحم البيت عشرات الجنود ورجال المخابرات وأدخلوا أبي معهم… وبدأو في قلب البيت… ولا يمكن وصف صرخات الفرحة التي خرجت من الجنود عندما وجدوا جهاز الارسال وهنأوا بعضهم قائلين “مبروك” وأحنى أبي رأسه وهمس لنا: “آسف يا أولادي”. ويكمل عادل الذي غير اسمه إلى (رافي بن ديفيد) حسب الرواية الاسرائيلية: بعد القبض على والدي تركتنا السلطات المصرية وكنا في حالة يرثى لها… وأردت البكاء والصراخ ولم أستطع… فقد انتهى العالم بالنسبة لي… وبعد ساعات تحدث أخي محمد للمرة الأولى “ماذا عن أمي؟” يجب أن نحكي لها ما حدث. وفي الرابع والعشرين من أغسطس عام ١٩٧٤، في ساعات الصباح المبكر، وصلت أمي إلى البيت، وفي جيب سري بالحقيبة كانت تخفي قطع غيار الجهاز… وكانت قد اندهشت من عدم انتظار أبي لها في المطار، وسألت عند دخولها: “أين أبوكم؟” وكان العناق بيننا بارداً فقلت لقد سافر أبي إلى الريف، فهكذا طلب منا رجال المخابرات المصرية إخبارها. وفهمت أمي على الفور فلا يمكن الكذب على من يحيا في ظل الموت، فاقتحمت حجرة النوم للبحث عن الجهاز هناك ولم يكن الجهاز موجوداً، فجرت نحو الحمام كي تتخلص من المواد التي تحملها. لكن كان قد فات أوان ذلك، فقد اقتحم البيت اثنان من رجال المخابرات ، قال لها أحدهما: “حمداً لله على سلامتك يا دنيا”
فتظاهرت أمي بالبراءة وقالت:”من هي دنيا؟ أنا انشراح”… .
قالت ذلك بثقة فابتسم رجل المخابرات في رضا: “لقد اعترف زوجك بكل شيء”.
ذهبنا إلى مبنى المخابرات وأمام المبنى الذي كنت أعرفه جيداً “فقد التقطنا له بعض الصور” استقبلني رئيس النيابة العسكرية محمد السبكي وقال لي: “سترى أبويك قريباً”.
وفي التحقيق الأول معي أنكرت وقلت إنني لا أعرف شيئاً .